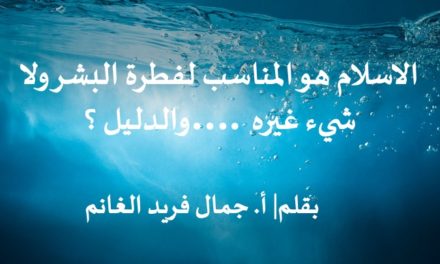منذ أن وصل إلى رأس هرم السلطة، لم يتوقف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن الإتيان من الأفعال والأقوال ما يفاجئ به الرأي العام محليا ودوليا، وربما يكون ذلك مقصوداً لذاته في كثير من الأوقات.
يمكن اعتبار المقابلة التي أجراها موقع إيلاف السعودي مع رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي جادي أيزينكوت، وهي الأولى من نوعها في وسيلة إعلام عربية، مؤشرا آخر على التحولات المثيرة التي ما فتئت تطرأ على التعامل السياسي للمملكة مع قضايا المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
في نفس اليوم الذي نشر فيه موقع إيلاف مقابلته مع العسكري الصهيوني، وهي المقابلة التي لقيت صدى واسعاً في وسائل الإعلام الصهيونية ليس أقلها التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس، نقل موقع ميدل إيست آي عن مسؤول أردني لم يسمه قوله إن الديوان الملكي الأردني يشعر بقلق شديد إزاء الاندفاع السعودي نحو السلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني، نظرا لأن ذلك يأتي في تقدير الأردنيين على حساب بلادهم وعلى حساب الفلسطينيين.
وعلى الرغم من أن الأردن لديه معاهدة سلام مع إسرائيل منذ عام 1994 إلا أنه بات يخشى من رد الفعل الشعبي إذا ما وقع السعوديون معاهدة خاصة بهم تتضمن تنازلاً عن حق العودة الفلسطيني.
على كل حال، لا ينبغي أن يفهم من ذلك أن التقارب السعودي الإسرائيلي لم يبدأ إلا بعد صعود محمد بن سلمان إلى سدة الحكم في المملكة.
فلقد شهدت السنوات الماضية اتصالات ولقاءات عديدة قام بها أفراد سعوديون، يبدو في الظاهر أنهم يتصرفون بشكل فردي – وإن كان يستحيل عليهم أن يفعلوا ذلك دون إذن أو مباركة أو ضوء أخضر من أولي الأمر في الرياض، للبحث عن فرص للتفاهم مع الإسرائيليين ولبناء جسور التعاون والتنسيق معهم.
ومن هذه الشخصيات اثنان لم يتحرجا في الشهور الأخيرة عن الظهور علانية مع مسؤولين إسرائيليين سابقين أو حاليين اجتمعوا بهم داخل أو على هامش مؤتمرات ومنتديات دولية في أوروبا أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بل فام أحدهما بزيارة إلى فلسطين المحتلة التقيا خلالها بالعديد من كبار المسؤولين الصهاينة.
أما الأول فهو رئيس جهاز المخابرات السعودي السابق الأمير تركي الفيصل، وأما الثاني فهو الضابط السابق أنور عشقي.
يعود تاريخ الاهتمام السعودي بفتح علاقات مع الكيان الصهيوني على الأقل إلى سنة 1981، وهي السنة التي انعقد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر منها مؤتمر القمة العربية في مدينة فاس المغربية، والذي تقدم فيه ولي العهد السعودي آنذاك الأمير فهد بن عبد العزيز بمبادرة من ثمان نقاط لإحلال السلام في الشرق الأوسط خلاصتها اعتراف العرب بإسرائيل مقابل انسحابها من الضفة الغربية وقطاع غزة.
جاءت هذه المبادرة بعد أقل من ثلاثة أعوام على توقيع مصر السادات معاهدة سلام في كامب دافيد مع الكيان الصهيوني، وتحديداً في عام 1978. إلا أن مبادرة فهد بن عبد العزيز لم تر النور بسبب إخفاقها في الحصول على دعم عدد كبير من الحكومات العربية الأخرى آنذاك.
وبعد عشرين عاماً تقريباً جدد السعوديون مسعاهم، وتمكنوا هذه المرة من الحصول على ما يشبه الإجماع العربي حينما تقدم ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز بمبادرته للقمة العربية المنعقدة في بيروت عام 2002، فتبناها العرب وأصبحت تسمى المبادرة العربية للسلام.
إلا أن المبادرة التي منحت إسرائيل اعترافا عربيا وتطبيعا شاملا مقابل انسحابها إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، لم تحظ بقبول الإسرائيليين، أو على الأقل ليس بدون الكثير من التحفظات.
وعودة إلى الحاضر، يمكن القول بأن الاندفاع السعودي الحالي نحو تطبيع العلاقات مع الصهاينة ناجم عن رؤية سعودية ترى فرصة سانحة قد لا تعوض فيما طرأ على المشهد السياسي في المنطقة وفي العالم من تحولات دراماتيكية.
بادئ ذي بدء، يشعر السعوديون بنشوة الانتصار بعد أن تمكنوا -ومعهم دولة الإمارات العربية المتحدة- من إفشال مشاريع التحول الديمقراطي في المنطقة العربية، حيث افترست الثورة المضادة التي خططوا لها ومولوها ثورات الربيع العربي فأجهضتها.
وهم يرون أن نجاحهم يتمثل في استعادة المنظومة القديمة وترسيخها، الأمر الذي يمكنهم الآن من إحكام قبضتهم على السلطة ومن الاستمرار في احتكار الثروة والقرار.
ونتيجة للهزيمة التي لحقت بالربيع العربي وانهيار ما كان يعرف بمعسكر المقاومة والممانعة -وهو تحالف شهد عصره الذهبي قبيل انطلاق الربيع العربي وشمل كلا من إيران وسوريا وحزب الله وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وبعض الفصائل المنضوية ضمن إطار منظمة التحرير فيما عدا حركة فتح- وجد الفلسطينيون أنفسهم يزج بهم في أزمة شديدة غير مسبوقة وباتت فصائلهم مقاومتهم، وعلى رأسها حماس، تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب محيط عربي معاد للغاية وحصار خانق من كل الاتجاهات.
ثم جاء دونالد ترامب، والذي شكل وصوله إلى البيت الأبيض منعطفا في السياسة الأمريكية أذن ببدء مرحلة جديدة ومقاربة مختلفة في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط.
ويبدو أن أسلوب ترامب في ممارسة السياسية كما لو كانت سلسلة من الصفقات التجارية، لا محل للقيم والمبادئ فيها ولا حتى لمجرد ذر الرماد في العيون، راق للأنظمة الملكية الحاكمة في منطقة الخليج وللعسكر الذين يهيمنون على مقاليد الأمور في مصر، الذين وأدوا للتو حركات التغيير التي كانت تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ولم تعد أسماعهم تطيق مزيداً من هذا الإنشاد أياً كان مصدره.
وكانت أول صفقة تجارية تبرم مع إدارة ترامب هي الموافقة على تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد والإقرار بأنه سيكون خليفة والده على عرش السعودية مقابل ما يقرب من نصف تريليون دولار تعهدت السعودية باستثمارها داخل الولايات المتحدة.
وهي الصفقة التي مهدت الطريق أيضاً باتجاه تطبيع العلاقات بين دول الخليج والكيان الصهيوني.
وقد اشتهر أن عراب الصفقة كان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وأنها تمت واستحكمت في قمة الرياض التي دُعي إليها زعماء خمسين دولة في أنحاء العالم الإسلامي للقاء الرئيس الأمريكي الجديد الذي اختار أن تكون السعودية هي أول بلد يزوره بعد توليه الرئاسة.
وكان برفقة الرئيس في رحلته تلك عدد من أفراد عائلته بمن فيهم مستشاره لشؤون الشرق الأوسط وزوج ابنته جاريد كوشنر، المعروف في الأوساط الأمريكية بعلاقاته الخاصة والوطيدة بالكيان الصهيوني تجارياً وسياسياً وعقائدياً أيضاً.
ما من شك في أن إيران والفصائل التي تعمل بالوكالة عنها وفرت لولي العهد السعودي ذرائع مفيدة جداً حتى ينطلق بأقصى سرعة ممكنة باتجاه إبرام صفقة سلام مع إسرائيل. فبعد أن منيت سياساته بالفشل في اليمن وفي سوريا وفي العراق، وجدت المملكة العربية السعودية نفسها قد فقدت مساحات واسعة من النفوذ لصالح الإيرانيين الذي لم يترددوا في أكثر من مناسبة في التبجح بأنهم باتوا يحكمون عواصم أربع دول عربية: لبنان وسوريا والعراق واليمن.
وإزاء ما جرى من تطورات لم تعد المملكة العربية السعودية تجد حرجاً في أن تقول بأن رؤيتها لإيران وحزب الله تتطابق تماماً مع الرؤية الإسرائيلية. ولذلك يسود انطباع لدى كثير من المراقبين بأن العداوة المشتركة لإيران، وهو البلد الذي يعتقد السعوديون والإسرائيليون على حد سواء أنه يشكل أكبر مصدر للخطر عليهما، هي التي قربت النظامين في الرياض وتل أبيب من بعضهما البعض. ولقد شاع مؤخراً بأن الأمير السعودي الذي زار الكيان الصهيوني على رأس وفد سعودي رفيع المستوى لم يكن سوى ولي العهد محمد بن سلمان ذاته.
إلا أن العامل الأهم على الإطلاق في الاندفاع السعودي نحو نسج علاقات حميمية مع الكيان الصهيوني هو رغبة محمد بن سلمان المحمومة في أن يصبح ملك البلاد ولأن يحظى في ذلك بمباركة سيد البيت الأبيض.
ولقد أثبت الأمير أنه على استعداد لفعل كل ما هو مطلوب ودفع أي ثمن مقابل تلبية هذه الحاجة الماسة لديه.
ولذلك يرجح عدد من المتابعين للشأن السعودي أن يكون للأمر علاقة مباشرة بسلسلة الإجراءات التي أمر بها الأمير لقمع أي معارضة محلية محتملة. فمن خلال تغييب رموز المجتمع من علماء ومفكرين وأكاديميين ورجال أعمال وحتى أمراء من أبناء عمومته ومن كبار التجار وملاك كبريات المؤسسات الإعلامية ومن خلال سحب البساط تماماً من تحت أقدام حراس المؤسسة الدينية التقليدية، يعتقد محمد بن سلمان بأن طريقه قد عبد تماماً ولم يبق فيه عقبة تذكر أو يحسب لها حساب.
كما لا يستبعد بتاتاً أن يكون لمهزلة احتجاز رئيس الوزراء اللبناني وإجباره على إعلان استقالته من داخل العاصمة السعودية، الرياض، علاقة بذلك. يعتقد على نطاق واسع داخل الدوائر الغربية أن السعوديين سعوا لإشعال أزمة سياسية، انطلاقاً من حسبة قادتهم إلى الظن بأن الأزمة يمكن أن تتفاقم فتؤدي إلى مواجهة إسرائيلية إيرانية في لبنان، فيما سيكون، لو حصل، أول تعاون مهم، وصارخ، بين المملكة العربية السعودية والدولة العبرية.
ولذلك لم يتوان زعيم حزب الله حسن نصر الله عن التصريح في خطابه المتلفز بعد أيام قليلة على استقالة الحريري إن لدى جماعته معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة تفيد بأن السعودية أبدت الاستعداد لتمويل الحرب الإسرائيلية القادمة على حزب الله ولو كلفت عشرات المليارات من الدولارات.
ولا يفوتنا أن نذكر أن الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها الأسابيع الأخيرة شملت دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالحضور إلى الرياض، فلما جاءها قيل لها حسبما ورد في تسريبات صحفية إن عليه الاختيار بين أن يتعاون مع مبادرة الرئيس ترامب لحل القضية الفلسطينية أو أن يرحل.
ويعتقد أن هذا الإجراء السعودي إنما قُصد منه تقديم خدمة لمستشار ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر الذي زار الرياض مؤخراً بعد أن كلفه “عمه” بمهمة تعبيد الطريق أمام المبادرة.
شاعت مؤخراً توقعات أشارت إليها صحيفة ديلي ميل البريطانية بما يفيد أن الأسبوع القادم سيشهد تتويج محمد بن سلمان ملكاً على البلاد بعد أن يتنازل والده له عن العرش.
إذا صدقت هذه التوقعات فقد لا يطول المقام بالسعوديين بعد ذلك قبل أن يروا بأعينهم راية الكيان الصهيوني ترفرف من على سطح إحدى البنايات في مدينة الرياض.